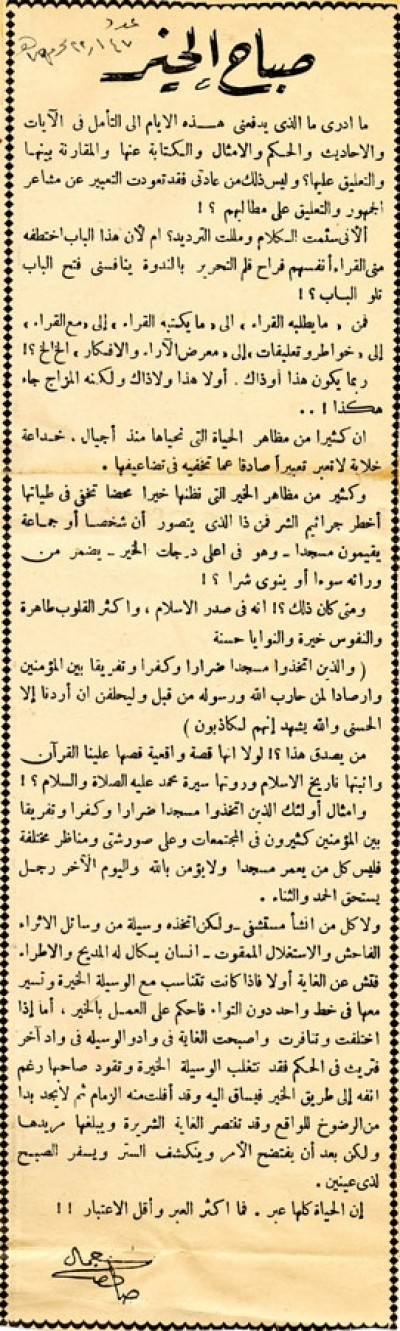ما أدرى ما الذي يدفعني هذه الأيام إلى التأمل في الآيات والأحاديث والحكم والأمثال والكتابة عنها والمقارنة بينها والتعليق عليها؟ وليس ذلك من عادتي فقد تعودت التعبير عن مشاعر الجمهور والتعليق على مطالبهم؟!
ألا أني سئمت الكلام ومللت الترديد؟ أم لأن هذا الباب اختطفه منى القراء أنفسهم فراح قلم التحرير بالندوة ينافسني فتح الباب تلو الباب؟!
فمن "ما يطلبه القراء" إلى "ما يكتبه القراء" إلى "مع القراء" إلى "خواطر وتعليقات" إلى "معرض الآراء والأفكار" إلخ إلخ؟!
ربما يكون هذا أو ذاك، أو لا هذا ولا ذاك ولكنه المزاج جاء هكذا!
إن كثيراً من مظاهر الحياة التي نحياها منذ أجيال، خداعة خلابة لا تعبر تعبيراً صادقاً عما تخفيه في تضاعيفها.
وكثير من مظاهر الخير التي نظنها خيراً محضاً تخفي في طياتها أخطر جراثيم الشر فمن ذا الذي يتصور أن شخصاً أو جماعة يقيمون مسجداً – وهو في أعلى درجات الخير – يضمر من ورائه سوءاً أو ينوى شراً؟!
ومتى كان ذلك؟! أنه في صدر الإسلام، وأكثر القلوب طاهرة والنفوس خيرة والنوايا حسنة.
(والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون).
من يصدق هذا؟! لولا أنها قصة واقعية قصها علينا القرآن وأثبتها تاريخ الإسلام وروتها سيرة محمد عليه الصلاة والسلام؟!
وأمثال أولئك الذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين كثيرون في المجتمعات وعلى صور شتى ومناظر مختلفة فليس كل من يعمر مسجداً ولا يؤمن بالله واليوم الآخر رجل يستحق الحمد والثناء.
ولا كل من أنشأ مستشفي – ولكن اتخذه وسيلة من وسائل الإثراء الفاحش والاستغلال الممقوتة – إنسان يكال له المديح والإطراء فتش عن الغاية أولاً فإذا كانت تتناسب مع الوسيلة الخيرة وتسير معها في خط واحد دون إلتواء فاحكم على العمل بالخير، أما إذا اختلفت وتنافرت وأصبحت الغاية في واد والوسيلة في واد آخر فتريث في الحكم فقد تتغلب الوسيلة الخيرة وتقود صاحبها رغم أنفه إلى طريق الخير فيساق إليه وقد أفلت منه الزمام ثم لا يجد بداً من الرضوخ للواقع وقد تنتصر الغاية الشريرة ويبلغها مريدها ولكن بعد أن يفتضح الأمر وينكشف الستر ويسفر الصبح لذى عينين.
إن الحياة كلها عبر، فما أكثر العبر وأقل الاعتبار!!